الحالة التي عاشها الشرق الإسلامي وخاصة في المشرق العربي، وانكشاف حجم الهشاشة التي يعيشها، وضعف ممانعته أمام أي توظيف سياسي، هي بعض العوامل المسؤولة عن التخلف والضياع الذي نهش منه، وخاصة في دائرة تحديد مساحة الخلاف العلمي والفكري من قطعيات التضليل والتكفير.
وقد برزت حرب الإقصاء في مراحل تاريخية عدة، وليس في مرحلة الصراع بين المدارس السنية الكبرى والسلفية الإقليمية والتي أطلق عليها "الوهابية" فقط، وإن كانت دائرة الصراع المسلح خلالها أكبر، وخاصة مع اختلاطها بحروب النفوذ الأخيرة للدولة العثمانية، وما صاحبها من بغي متبادل.
ونقصد هنا ولضرورات الفكر المطلق، الذي يجب أن يرتفع عن التوظيف السياسي والنفسي، أن هذه الظواهر تمثل كلها حالات تخلف، بما فيها صراع الحنابلة المتقدمين، وأشاعرة صلاح الدين معهم والتضييق عليهم، وما جرى ما بين الشافعية والحنابلة، وما جرى قبل ذلك من المعتزلة، وقس على ذلك حملات توظيف سياسي بشعة عاشتها الأمة، وصولا إلى تطرف السلفية الطائفية في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة، وهي في هذا السياق نماذج لفتنة العقل المسلم.
ومعلوم أنه لا يجوز أن يُلزم المسلم بتقديس أي منها، فقد تعبده الله بالإسلام لا بها، ثم عليه ينظر ويُبحر في إنتاج الفقه والفكر الإسلامي وفق قواعد التأصيل الكبرى، والتدرج الذي أسّس لقواعد العلم الشرعية والمعرفية في ثقافة التشريع الإسلامي، الذي جُعل التجديد من أساسياته بنص حديث رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يُرهن الناس في هذه "القولبات" الضيقة والصراعات المزمنة وآثارها المدمرة، وتغيب رسالة الوحي المبين.
ومن هنا فإن مؤتمر الشيشان الذي نُظم في غروزني، بتمويل من مؤسسة خليجية اتخذت حالة صوفية غطاء لها -وهذه المدرسة لا تُمثل مدارس السلوك الكبرى، بل تمثل جناحا يمينيا صغيرا منها- ودُعم بغطاء سياسي ديني من مصر، جاء -كما اتضح من سياقاته- ضمن مشروع توظيف واستثمار سياسي.
ولكن عددا كبيرا من المشاركين كانت لهم مواقف فكرية في مدارسهم وشخصيات عاشت مظالم شرسة، ساهمت في دفعهم لهذا التوظيف، دون أن يكون ذلك ضمن معرفة كل المشاركين، بأن المؤتمر كان ضمن اتفاق لطرف خليجي مع الغرب، لتعزيز ملف تجريم "الوهابية السلفية" تحديدا دون غيرها من السلفيات، تمهيدا لخرائط المنطقة الجديدة.
وكان من الممكن أن يُتعامل مع هذا التوظيف فورا، ويُعزل هدف التفجير المذهبي وسط الحالة السنية، والذي عزز مقاصد المشروع الغربي من المؤتمر، ولا يعني ذلك أن الغرب فصل برنامجه، ولكنه يتقاطع بالضرورة مع الملف الذي يُعد للجغرافيا السعودية، وبالتالي يعي أولئك المشاركون أن هذا المشروع لن يُعالج التطرف والغلو، بقدر ما سيُستخدم كما جرى مع حالة حزب البعث العراقي، لكن بصورة أوسع، تضرب ما تبقى من ممانعة للشرق الإسلامي.
لكن المشكلة أن ردة الفعل التي تحولت وكأنها تخدم بالفعل فتنة الغرب الكبرى، توجهت لحملة تكفير وتضليل واحتقار معنوي بالغ، ضد مدارس السنة الأشعرية والماتوريدية ومسالك التصوف، والذين هم غالبية العالم السني.
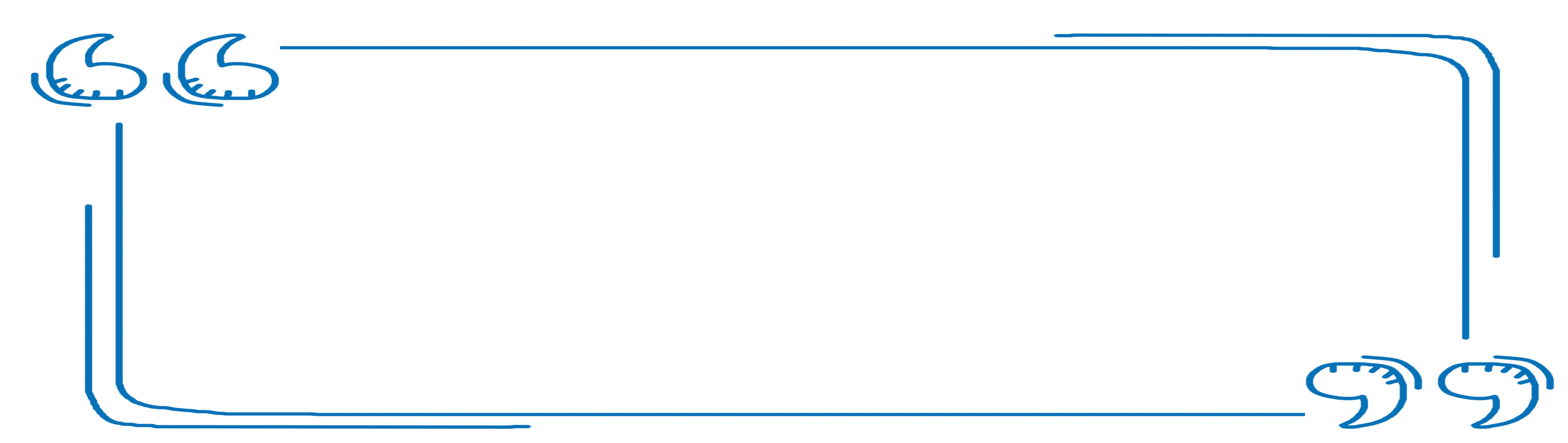
ولم يعلم غالبيتهم الكبرى بهذا المؤتمر، بل إن فكرة مباركة الروس المعنوية لقيادة المؤتمر السياسية، في ظل حربهم الشعواء على سوريا، كانت محل إدانة مخجلة للمؤتمرين، من قبل هذه المدارس وخاصة في الموقف من ثورة سوريا.
إن أخطر ما تم توظيفه، هو ذلك العزف في التقارير الإعلامية على الماتوريدية والنقشبندية، وهما أكبر مدراس الانتماء في الأمة التركية، والمقصود بالأمة التركية، امتداد القومية التترية الواسعة وشعوبها، ثم بقية الأشقاء الأعاجم في شرق آسيا، وهي اليوم معقل الشرق السني في مقابل سنة المشرق العربي، وإظهار أتباع هذه المدارس بأنهم حفنة من الراقصين المخرفين، ثم نعتهم بأفظع الأوصاف وإن كان أكثره دون التكفير، واحتجاج هذه الحملات بأنها لم تُكفرهم، ولكن ترد على إخراجهم للسلفية (الوهابية) من دائرة السنة.
تبدو هذه الأفكار في الوهلة الأولى عبثية لا تستحق الوقوف، ولكن الكارثة أنها كانت مادة سياسية وإعلامية واسعة الاستقطاب الشعبي، تخدم بالفعل موظفي المؤتمر من حيث خططوا لهذا العنصر أو لم يفعلوا.
إن فرز مدرسة أهل الأثر، والتي هي ثالث أضلع مسالك الاعتقاد في مدراس السنة فيما يرد من اختلاف فروع العقائد كان واضحا أنه قرار سياسي محدد ليسهل تحقيق الملف الدولي الذي أشرنا له، وكان رفض تحفظ شيخ الأزهر د. الطيب وموقف الشريف حاتم العوني أحد أبرز علماء الحجاز، وهو من أطياف المدرسة السلفية ذاتها، من قبل منظمي مؤتمر غروزني، يُشير إلى المادة السياسية في التوظيف.
ولعل بيان أمانة كبار العلماء السعودية جاء في اتجاه إيجابي مهم، ضمِن تحييد أكبر قدر من حملة الصراع المذهبي التي اشتعلت، وهو خطوة جيدة تستحق الإشادة، لكن السؤال الكبير، هو إن كان هذا الملف فاعل في الأرشيف الغربي فكيف يتم عزله؟
إن رفض الاعتراف بآثار الصراع، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، والحروب المهلكة، وخنق الفكر والحريات الشخصية التي جرت على هامش هذا الصراع المذهبي السني لن يحقق نتيجة، فالحقائق التاريخية وانفجار الأرشيف المعلوماتي في هذا الزمن، لا يمكن تغطيته، كما أن إعادة حرب البسوس المذهبية في عالم السنة، بل وحتى مع الطوائف، ضلال ديني وقصور عقلي.
ولكون المعالجة الفكرية والأخلاقيات المذهبية تحتاج لأزمنة طويلة، فإن تدارك الأمر يتم عبر توافق سياسي وميثاق فكري، يُحدد علاقة جديدة بين مدارس السنة من أنفسهم دون إقصاء, مع بقاء النقد العلمي المشروع فهذا حق للجميع, ويتحدون في موقفهم من الغلو مسلحا كان أو غير مسلح, ليصفوا خطابهم جميعا من أي استثمار للمتطرفين أو المشروع الغربي، وتلتزم المدارس أدبيا بمراجعة أي نصوص متطرفة جديدة, يرفضها الاعتدال الشرعي في مناهجها الفاعلة، وليست مسؤولة عن كل الإرث المنحرف، في هذه المدرسة أو تلك.
إن التوظيف السياسي الذي تعززت به بعض المذاهب، وسطت بواسطته على غيرها، هو موقف سياسي لا عقيدة دينية تُلزم بها سنة رسول الله، ومناهجها المختلفة بما فيها السلفية الأثرية التي وقفت عند الإمام ابن تيمية، وإعلان كل هذه المراحل وما جرى فيها، عبر تطبيق النص القرآني: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (البقرة 134).
هذا النص المقدس العظيم، يحمل في ذاته مخرجا سياسيا لأزمات الأمة وصراع مذاهب السنة، ومعالجة أزمة الطوائف الأخرى، ولكنّ تلاوته لا تعني أبدا الوقوف عند ترتيله، وإنما العمل ببرنامج تواصلي ضخم يطبق معانيه، وخاصة بين الرئاسة الدينية في تركيا، والرئاسة الدينية في السعودية، بتشجيع سياسي صريح من قيادة الدولتين، وهو ما يجب أن يُدعم من قبل التيارات الفكرية المختلفة مهما بلغ صراعها السياسي، فإن مصالحها السياسية في تأجيج الحرب المذهبية السنية، موسم عابر سريع الزوال، فيما ورطتها في حرب الفتنة الكبرى، هي الحالقة، تحلق الدين وتُسقط ما تبقى من بلاد المسلمين.
مدير مكتب دراسات الشرق الإسلامي بإسطنبول












